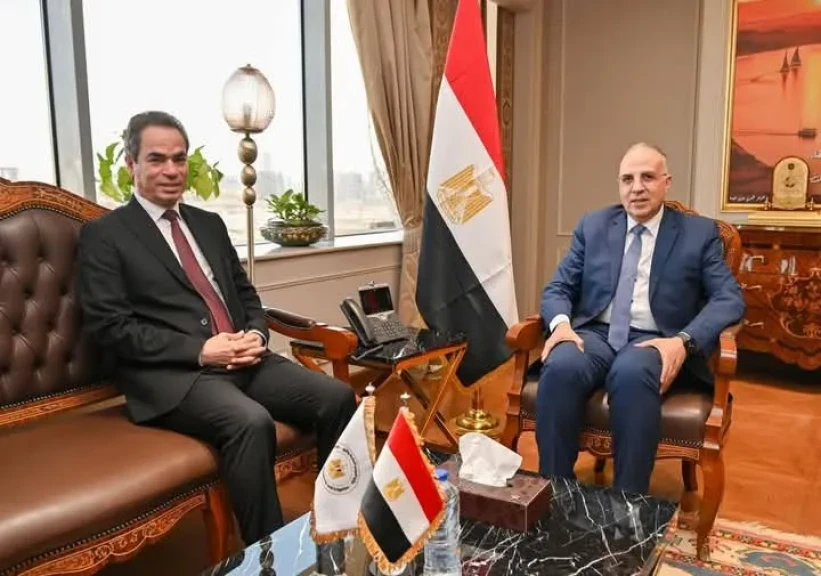سماحة النبي ”صلى الله عليه وسلم” .. بقلم - فضيلة الشيخ/ عبدالمنعم الطاهر من علماء الأزهر الشريف

سماحة النبي صلى الله عليه وسلم
بقلم فضيلة الشيخ/ عبدالمنعم الطاهر أحمد سليمان
من علماء الأزهر الشريف
الحمدُ لله، الحمدُ لله الذي تكَّرمَ علينا بدين الإسلام، وجعل السماحةَ فيه منهجًا للأنامِ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ له شرَّفنا بهذا الدين، وأمرَنا باتباعِ هَديِه المُبين، وأشهدُ أن نبيَّنَا محمدًا عبدُه ورسولُه، بعثَهُ ربُّه رحمةً للعالمين، صلَّى الله عليه وعلى آله في الأولين والآخرين، وصحابتِه الغرِّ الميامين، ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين.
أما بعدُ .. معاشر المؤمنين: فأُوصِي نفسي وإياكم بتقوَى الله - عزَّ وجلَّ -.
أمةَ الإسلام: نشهدُ في عالَمنا اليوم إلصاقَ شُبَهٍ بالإسلام وأهله، تتمثَّلُ في وصف هذا الدين العظيم وأتباعِه بالتعصُّب والطائفية، والعُنف والشدة. والإسلامُ بريءٌ من ذلك؛ فهو دين الرحمة والعدالة، والتسامُح والمحبة.
فعن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: سُئل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: أيُّ الأديان أحبُّ إلى الله - عزَّ وجل -؟ قال: «الحنيفيةُ السَّمحةُ» (رواه أحمد بسندٍ حسن).
فهي حنيفيَّةٌ في التوحيد، سَمحَة في العمل.
ولما بعَثَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مُعاذًا وأبا موسى إلى اليمن، قال: «يسِّرا ولا تُعسِّرا، وبشِّرا ولا تُنفِّرا، وتطاوَعا ولا تختَلِفَا» (متفقٌ عليه).
وصدَقَ الله إذ يقول: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة: 6].
قال ابن كثيرٍ - رحمه الله -: "أي: لعلكم تشكُرون نعَمَه عليكم فيما شرَعَه لكم؛ من التوسِعَة والرأفة والرحمة، والتسهيل والسماحة". اهـ كلامُه - رحمه الله -.
وها هو -صلى الله عليه وسلم- يحُثُّ على السماحة في المُعامَلة، والتحلِّي بمعالي الأمور، وتَرك المُشاحَّة، ويدعُو -صلى الله عليه وسلم- بالرحمة لمن تحَلَّى بذلك.
ففي "صحيح البخاري": عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «رحِمَ اللهُ رجلاً سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اشترَى، وإذا اقْتضَى».
وما خُيِّرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بين أمرَين، إلا اختارَ أيسَرَهما ما لم يكُن إثمًا.
قال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً سهلاً".
قال النووي - رحمه الله -: "أي: سهلَ الخُلُق، كريمَ الشمائل، لطيفًا مُيسَّرًا في الخُلُق، كما قال الله تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) [القلم: 4].
وتتجلَّى هذه السماحةُ والرحمةُ - يا عباد الله - في صُورٍ شتَّى من حياةِ النبي -صلى الله عليه وسلم-، في عباداته ومُعاملاته، وفي سُلُوكه وأخلاقِه، مع قرَابَته وأصحابه، وأصدقائِه وأعدائِه، فكان -صلى الله عليه وسلم- رحمةً للخلق كلِّهم، دون اعتِبارٍ لجِنسِهم أو دينهم.
ففي غزوة بدرٍ الكبرى، كان مع أسرَى المشركين أبو العاصِ بن الربيع، زوجُ زينب بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما بعَثَ أهلُ مكة في فِداء أسراهم، بعثَت زينبُ في فِداءِ أبي العاصِ بمالٍ، وبعَثَت فيه بقِلادةٍ لها كانت عند خديجة، أدخَلَتها بها على أبي العاصِ، فلما رآها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، رقَّ لها رقَّةً شديدةً، وترحَّم على خديجة، وقال لأصحابه: «إن رأيتُم أن تُطلِقُوا لها أسيرَها، وترُدُّوا عليها الذي لها»، قالوا: نعم يا رسول الله (رواه أبو داود بسندٍ حسن، من حديث عائشةَ - رضي الله عنها وأرضاها -.
وفي "الصحيحين" و"مسند الإمام أحمد"، من حديث جابرٍ - رضي الله عنهما - قال: كنَّا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذاتِ الرِّقاع، فإذا أتَينَا على شجرةٍ ظَليلَة، تركنَاها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجاء رجلٌ من المشركين حتى قام على رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالسيفِ، فقال: من يمنَعُك مني؟ قال: «الله»، فسقطَ السيفُ من يدِه، فأخذَه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «من يمنَعُك منِّي؟»، قال: كُن كخير آخِذٍ، قال: «أتشهَدُ أن لا إله إلا الله؟»، قال: لا، ولكني أُعاهِدُك ألا أُقاتِلَك، ولا أكونُ مع قومٍ يُقاتِلُونك. فخلَّى سبيلَه -صلى الله عليه وسلم-.
قال: فذهَبَ إلى أصحابه فقال: قد جِئتُكم من عند خير الناس.
فلم يُجبِره -صلى الله عليه وسلم- على الإسلام، ولم يُعاقِبه على فِعلَته، فدخَلَ الإسلامُ في قلبه، ورجَعَ إلى قومه، فاهتَدَى به خلقٌ كثير.
ومن عظيم سماحَته -صلى الله عليه وسلم-: دُعاؤه للمشركين رجاءَ أن يهدِي الله قلوبَهم للإسلام.
ففي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قدِمَ الطُّفيلُ وأصحابُه فقالوا: يا رسول الله! إن دَوسًا قد كفَرَت وأبَت، فادعُ الله عليه، فقيل: هلَكَت دَوس، هلَكَت دَوس، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «اللهمَّ اهدِ دَوْسًا وائتِ بهم، اللهمَّ اهدِ دَوْسًا وائتِ بهم».
ولقد فطِنَ إلى ذلك يهُود، فكانوا يتظاهَرُون بالعُطاس عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، رجاءَ أن يدعُو لهم بالرحمة، فلم يحرِمهم -صلى الله عليه وسلم- من الدعاء لهم بالهدايةِ والصلاحِ.
ففي "سنن الترمذي" بسندٍ صحيحٍ، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: كان اليهود يتعاطَسُون عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، يرجُون أن يقول لهم: يرحَمُكم الله، فيقولُ -صلى الله عليه وسلم-: «يهدِيكم اللهُ ويُصلِحُ بالَكم».
وصدقَ اللهُ إذ يقول: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) [الأنبياء: 107].
فكان -صلى الله عليه وسلم- أحسَنَ الناس خُلُقًا، وأوسَعَهم صَدرًا، وأصدَقهم حديثًا، وأليَنَهم عريكةً، وأكرَمهم عِشرة، كثيرَ التبسُّم، طيِّبَ الكلام، وَصُولاَ للأرحام، حريصًا على السلام وإفشاء السلام، لا يُحبُّ أن يقوم له أحدٌ من المجلس، ويجلِسُ حيث ينتهي به المجلس، يُخالِطُ الناسَ فيُرشِدُهم إلى الأمانة، وينهَاهم عن الغشِّ والخيانة، حسَنَ المُصاحَبة والمُعاشَرة، يغُضُّ عن أخطاء وهفَوَات من خالَطَه، يقبَلُ معذرةَ المُسيءِ منهم، وإذا بلَغَه خطأُ أحدٍ منهم، لا يُقابِلُه بما يكرَه؛ بل يقول: «ما بالُ أقوامٍ يفعَلُون كذا وكذا؟».
يتلطَّفُ إلى من حولَه، حتى يظُنَّ كلُّ واحدٍ منهم أنه أحبُّ الناسِ إليه، يستَشيرُ ذوِي الرأي والمشُورة منهم، مع أنه تميَّزَ بتأييد الوحي عنهم، يُشارِكُ أصحابَه فيما يعمَلون، ويتحمَّلُ من الصعاب ما يتحمَّلون، ويُوجِزُ ذلك الخليفةُ الراشدُ عثمانُ - رضي الله عنه وأرضاه - بقولِه في بيان سماحةِ النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيقول: "إنا والله قد صحِبنا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- في السفر والحضر، فكان يعودُ مرضَانا، ويتبَعُ جنائِزَنا، ويغزُو معَنا، ويُواسِينا بالقليل والكثير" (رواه أحمد بإسنادٍ حسن).
أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ) [التوبة: 128].
إن مما لا شكَّ فيه: أن السماحة والرحمة تُثمِرُ مُجتمعًا يسودُه الحبُّ والتراحُم، والتعاوُنُ والتلاحُم، وكما قيل: النفسُ السَّمحةُ كالأرض الطيبة، إن أردتَّ عُبورَها هانَت، وإن أردتَّ زراعتَها لانَت، وإن أردتَّ البناءَ فيها سهُلَت، وإن شئتَ النوم عليها تمهَّدَت.
وفي "صحيح البخاري"، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه وأرضاه -، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الدينَ يُسرٌ، ولن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبَه، فسدِّدوا وقارِبُوا وأبشِرُوا، واستعِيُنوا بالغدوَةِ والرَّوْحةِ وشيءٍ من الدُّلْجَةِ».
سماحةٌ ويُسرٌ في العقائد والعبادات، والآداب والأخلاق؛ فعقيدتُه أصحُّ العقائد وأقوَمُها، وعباداتُه أحسن العبادات وأعدَلُها، وأخلاقُه أزكى الأخلاق وأتمُّها وأكمَلُها، فهو دينٌ لا حرَجَ فيه ولا شدَّة، ولا تعسيرَ ولا مشقَّة.
وقد ندَبَ الإسلام كثيرًا إلى التحلِّي بخُلُق السماحة في المُجتمعات، وجعل ذلك في مقام العبادات؛ فإظهارُ البشاشَة والبِشر عبادة، وإماطَةُ الأذى عن الطريق عبادة، وعيادةُ المريض عبادة، وإكرامُ الضيف عبادة، واللُّقمةُ يضَعُها الرجلُ في فَمِ زوجته عبادة، وشُكر الله تعالى على اليُسر والسماحة عبادة، وكفُّ الأذى عن الناس عبادة، وكلُّ عملٍ أُريدَ به وجه الله عبادة.
ففي "الصحيحين" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «كلَّ يومٍ تطلعُ فيهِ الشَّمسُ، تعدِلُ بين الاثنينِ صَدقةٌ، وتُعينُ الرَّجلَ في دابَّتِه فتحمِلُه علَيها أو تَرفعُ لهُ علَيها مَتاعَه صدقةٌ، والكلِمةُ الطَّيِّبةُ صَدقةٌ، وكلُّ خُطوةٍ تَمشِيها إلى الصَّلاةِ صدقةٌ، وتُميطُ الأذى عَن الطَّريقِ صدقةٌ».
إن سماحةَ الإسلام - يا عباد الله - تتجلَّى في عزَّة هذه الأمة بدينها، بإيمانها وعقيدتها، بتطبيقِها لشريعةِ ربها، فلم تكُن سماحتُه -صلى الله عليه وسلم- ورحمتُه لَتحُولَ بينه وبين إقامَة حدود الله، أو مُناصَرة المظلومين.
ففي "الصحيحين": لما سرَقَت المرأةُ المخزوميةُ، قطَعَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يدَها وقال: «وايْمُ اللهِ؛ لو أنَّ فاطِمَةَ بنتَ مُحمدٍ سَرَقَت لَقطَعَتُ يَدَها».
وفي "صحيح مسلم"، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ما رأيتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَجَدَ على سريةٍ ما وَجَدَ على السبعين الذين أُصيبُوا يومَ بئرِ معُونةَ، كانوا يُدعَونَ القرَّاءَ، فمكَثَ شهرًا يدعُو على قتَلَتهم.
ولما نقَضَت قُريشٌ عهدَها مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقتَلَت عشرين رجلاً من خُزاعة، غضِبَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وانتَصَر للمظلومين، فكان فتحُ مكة المُبين، ووقَفَ -صلى الله عليه وسلم- ها هنا على باب الكعبة، وقُريشٌ قد اجتَمَعُوا في المسجد الحرام، فقال: «يا معشرَ قريشٍ! ما ترَونَ أنِّي فاعلٌ فيكم؟»، قالوا: خيرًا، أخٌ كريمٌ، وابنُ أخٍ كريمٍ، قال: «اذهَبُوا فأنتم الطُّلَقاءُ».
ألا ما أجمَلَ العفوَ عند المقدِرة، والتواضُع عند النصر، والسماحةَ مع المُسيئِين، وكلُّ ذلك تمثَّلَ في رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
فلا إله إلا الله، ما أعظمَ هذا الدين! دينُ الخير والرحمة، والتسامُح والمحبة، والتآلُف وجمع الكلمة، والاعتِصام بالكتاب والسنة.













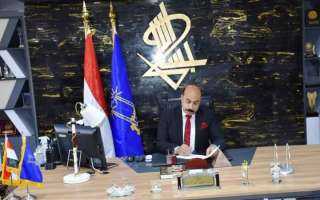







.jpg)